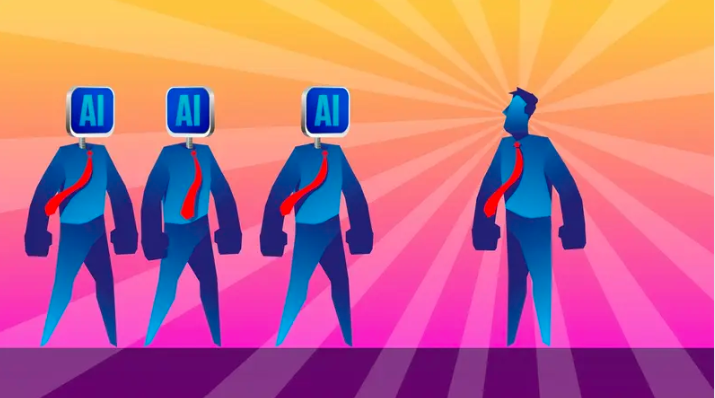في كتابه “سينما الأكستريم.. جماليات الحدود والتجاوز” يحلل ليث عبدالأمير سينما “الأَكسترَيم” أي “الحالات القصوى”، لافتا إلى أن الأكستريم مفهوم مرتبط بالحدود التي غالبا ما كانت هدفا لمنتجي الأفلام لتجاوزها والتعدي عليها.
ونقصد بالحدود هنا الضوابط والقوانين الاجتماعية والدينية والأخلاقية والسياسية التي تشكل في مجملها مجموع القواعد التي تحكم العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الأفراد أنفسهم.
الحالات القصوى
يتعلق موضوع الكتاب، الصادر عن مؤسسة أروقة للنشر بالأفلام، بتجاوز حدود النظرة التقليدية للفن، وعبور السور المحافظ؛ لكي يكشف على نحو مغاير كينونتنا وعالمنا اللذين نرفض رتابة إيقاعهما.
كما يشمل الأكستريم تلك الأفلام التي تذهب إلى أبعد مما تعودنا أن نراه، وإلى ما يقع خارج حدود مخزوننا الثقافي. حيث يرى عبدالأمير أنه “في السينما هناك عملية هدم لكل ما يمكن اعتباره مقدسا أو محرما أو ممنوعا، وفيها تحدث عملية خرق وتجاوز على الحدود المتأصلة في الوعي الجمعي للبشر وفي مداركهم الاجتماعية”.
ويحلل عبدالأمير الأكستريم في اثنى عشر فصلا، باعتباره موضوعا ولغة فنية، محتوى وشكلا سينمائيا، أسلوبا وحالة فنية، وكذلك يدرس تاريخ الفن والسينما حصريا لمعرفة جذور نشوء ظاهرة الأكستريم في فن الصور المتحركة وتأثير أفلام الحالات القصوى على المشاهد بما فيها طريقة التلقي،التي ترفض المصالحة بين حدود الذوق السائد والنظرة التقليدية.
ويلفت المؤلف إلى أن هناك صفات إبداعية ليست بالضرورة تدميرية أو خالية من الجدوى لحالة الأكستريم، فالزمن الذي نعيش فيه مشحون بالتوتر وغير مستقر، مما يفرض وجود إنسان حاد المزاج ميال للتطرف ومستقبل للأفكار الجديدة، وعليه، ربما يساعده الأكستريم على اتخاذ مواقف سليمة تخلصه من التطرف والغلو عندما يشير إلى حالته.
ويقول “هنالك توصيفات كثيرة لأفلام الأكستريم أطلقها مؤرخو الفن ونقاده، مثلا: الأفلام الصادمة أو المشاكسة والأفلام المفرطة والشاذة وسينما الأفلام الغريبة والعابرة للحدود”.
ويضيف “كما تندرج ضمن هذا الحقل الأفلام السوريالية والتعبيرية والأفلام الدادائية والمطالبة بالتحرر من الأشكال القديمة، حيث لا ممثلين ولا مقابلات، ولا حتى عناصر بصرية تقليدية، أشكال لونية من الخطوط والمنحنيات أو تشويه أو جزء من لقطة من الشريط السينمائي يلغي حضور الأشكال ووضوحها، كظهور مجسمات ضوئية على سطح الشاشة أو بقع سوداء تتساقط على بياض، كما في معظم الأفلام الدادائية”.
ويرى أن الغاية من كل هذا تشويه للشكل وتهديم للموضوع، فليس بالضرورة أن يرى المشاهد صورا إنما هو تجريد في المطلق، لكن ليس من دون جمال. فالعرض السينمائي الدادائي يضعنا وكأننا أمام لوحة فنية نتأملها وليس أمام سرد تنبغي متابعته.
أفلام الأكستريم تتميز عن غيرها في شكلها السينمائي فهي أفلام تجريبية تلجأ إلى الاستخدام المفرط للصوت والمونتاج
ويضيف عبدالأمير أن ثمة توصيفات أخرى أطلقها كبار نقاد الفن السابع مثل الأفلام “الملتهبة” و”المنتفضة” أو “التدميرية” بحسب آموس فوجل، والأفلام التهديمية التي تملك سلطة تحريك خيالاتنا بحسب أندريه بازان. لقد تم وضع الكثير من التوصيفات لأفلام الأكستريم في سلة واحدة دون إعطاء تحديدات دقيقة لطبيعتها، على الرغم من اختلاف مستويات العروض التي تقدمها ونوعية الجمهور الذي تخاطبه وطريقة استقباله لها، وبعضها يولد لدى المشاهد تساؤلات عن حدود قدرة جسد المرء باعتباره هشا قابلا للتدمير في أي لحظة ولأدنى سبب.
ويشير إلى أنه بسبب حداثة هذا النوع السينمائي وخصوصيته الدقيقة ودينامية تطوره، لم يتم الاستقرار على تسمية واحدة لنوع أفلام الأكستريم، وعليه نعتقد أن نعت هذه الأفلام بالأكستريم أو “الحالات القصوى” هو الأكثر قربا ودلالة، ذلك لأن سمة القصوى ترتبط فعليا بالحالة التي يصل فيها الإنسان إلى حد يتجاوز فيها إنسانيته، عابرا في الآن ذاته حدود الممكن والمتعارف عليه اجتماعيا، وفي المقابل تبعدنا صفة القصوى هذه عن الخلط مع مفهوم التطرف الذي أصبح راهنا مصطلحا سياسيا ودينيا واجتماعيا شائعا.
ويتابع عبدالأمير كيف أن الأكستريم ليس في حالة طارئة على فن الصور المتحركة وهي ظاهرة متأصلة في السينما كبنية فنية. وإذا سلمنا بوجودها ضمن بنيات العمل السينمائي، فما الذي يميز إذا لغة أفلام الأكستريم في السينما الروائية عن غيرها من الأجناس السينمائية؟ وهل يكفي تجاوز الحدود في تناول الموضوعات لكي يكون الفيلم بصبغة الأكستريم؟
وينقل عن الكاتبين آرون كيرن وجوناتان في كتابهما المشترك، الذي صدر بعنوان “سينما الأكستريم – الاستراتيجيات العاطفية في الإعلام العابر للحدود”، قولهما إن “ما يميز أفلام الأكستريم عن غيرها هو التشديد الذي يخص شكلها السينمائي، وهكذا، فهي أفلام تجريبية تلجأ إلى الاستخدام المفرط للصوت وكذلك المونتاج. فلا تعني الجثة العنف والدناءة. إن طريقة معالجة الموضوع هي التي تحدد درجة العنف وماهية الدناءة”.
بدايات الأكستريم
يرصد عبدالأمير الموضوعات الأكثر تداولا في فن الصور المتحركة حيث ينشط الأكستريم فيه، وهما موضوعا العنف والجنس تحديدا اللذان يتم تقديمهما على طبق جديد مختلف، أي طريقة العرض، والهدف صدم المشاهد والاحتفاء غالبا بمشاهد العنف والجسد لذاتهما فقط، لكن السينما تقدمهما بشكل وبأسلوب جديدين، أي دائما الموضوع نفسه ولكن طريقة العرض مختلفة.
ويوضح “نعم كلمة السر لدخول عالم أفلام الأكستريم هي الشكل. وتعتبر المؤثرات الصوتية في هذا النوع من الأفلام أكثر العناصر الفيلمية المعنية شيوعا بالشكل والخاصة بوسائل التعبير الفنية السينمائية. يتفنن منتجو الأفلام في استخدام الصوت بحالاته القصوى، فيجب عندما تنطلق رصاصة أن يكون صوتها مدويا، يستفز المشاهد، أو حين تنغرز سكين في جسد الضحية، فيجب سماع لحظة ملامسة الشفرة للجسد وتقطع الأنسجة، مع الإصرار على تضخيم صوت ارتطام أجساد الممثلين بالأرض إضافة إلى صرخاتهم وبكائهم”.
وتجبر أفلام العنف المتفرج المتفاعل معها بشكل كامل على شحذ السمع والبصر إلى أقصى مداهما، بحيث لا يستطيع تحاشي العنف مطلقا، وإن حاول إغماض عينيه هربا من مشهد مفزع فسوف يلاحقه الصوت، وهكذا يصبح المتفرج بين كماشتيهما، عندئذ، فلا مهرب له سوى الاستسلام لما يجري على الشاشة، وهو المطلوب من أفلام العنف تحقيقه.
وبنفس القدر يمكن مراقبة استخدام الموسيقى التصويرية اللاعبة على وتر المتفرج، فتخلق توترا وشدا في المشهد الدرامي (أو الوثائقي) حين تعلن عن حدوث شيء ما. وبهذه المناسبة، من الصعب مشاهدة أغلب هذه الأفلام دون موسيقى تصويرية، فلو جرب المرء مثلا مشاهدة فيلم “هالووين” (1978) دون موسيقى تصويرية، أو فيلم “غور” لجون كاربنتر، فستفشل حينئذ تجربته في التواصل مع الفيلم، لأنه سيكون مملا وباهتا، بل لا يمكن تحمله، والصورة لوحدها عاجزة عن خلق التأثير المطلوب لأن الموسيقى تحرك التوتر.
ويتتبع عبدالأمير بدايات الأكستريم وكيف أن سحر تأثير الحالة القصوى على الجمهور مر بمراحل مختلفة من النضج والتطور منذ تاريخ اختراع السينما، يقول “خلقت الحالة القصوى في بدايات فن الصور المتحركة، هي حالة من الدهشة في المشهد الذي صور اندفاع القطار باتجاه الجمهور، وبدا كأنه سيسحقه في أول عرض لـفيلم ‘وصول القطار إلى محطة لاسيوتا‘ الذي أقامه الأخوة لوميير في بوليفار كابوسين بباريس عام 1895. لقد شعر المشاهدون بالخوف من اندفاع القطار في اتجاههم، وحدثت الانطباعات ذاتها مع فيلم ‘سرقة القطار الكبرى‘ 1903 عندما وجه رجل العصابة فوهة مسدسه نحو الكاميرا، مما أثار فزع المشاهدين من الرصاصة التي ستنطلق في اتجاههم”.
ويضيف “كما مرت السينما الوثائقية بمراحل عديدة، خصوصا بعدما أخذ منتجو الأفلام يشتغلون على الشكل، بعيدا عن كونه عرضا محضا للصور. فانتقل روبرت فلاهيرتي اتجاه الشمال القصي في الإسكيمو، وصور ‘نانوك رجل الشمال‘ 1922، وذاك حدث كبير في تاريخ السينما، فقد سجل بداية تاريخ الفيلم الوثائقي، وبعد فترة قصيرة صور دزيغا فيرتوف ‘رجل الكاميرا‘ 1927 وهو قصيدة مستقبلية تحتفي بالمدينة والعلم، وعن فيلمه هذا كتب فيرتوف: أنا أحرر نفسي منذ اليوم وإلى الأبد من السكون البشري. أنا في حركة دائمة”.
ويبين عبدالأمير أن حركة فيرتوف دفعت بالفن الجديد إلى رحاب أوسع. ثم اشتغل في الوقت ذاته على موضوع المدينة المخرج الألماني فالتر روتمان في فيلم “برلين سيمفونيا مدينة عظيمة” 1927 وهو تشكيل سيمفوني رائع للمشروعات الصناعية في برلين، برباط شاعري ما بين حركة الناس والعمارة. وخرجت أفلام عدة لاحقا أطلق عليها أفلام سيمفونيا المدينة.
أما فيلم “حول نيس” 1930 لجان فيغو فهو من أوائل الأفلام الوثائقية التي اتجهت نحو السوريالية واللغة النقدية، حيث كونت تركيبا غريبا للصور إمعانا في السخرية. وفي خيار شعري غير مألوف، صور المخرج الهولندي جوريس إيفانس فيلم “مطر” 1929 عن قصيدة مرئية صامتة بالأبيض والأسود.
أما فيلم “موندو كان” 1962 فقد شارك في إخراجه ثلاثة من المخرجين الإيطاليين هم جيالتيرو جاكوبيتي، فرانكو بروسبيري وباولو كافارا، لقد كان فيلما “بحسب الصحافة الفرنسية” وثائقيا ـ صادما، وذلك بسبب محاولته الاقتراب من السر الأعظم، وهو الموت، مستعملا مشاهد جنسية غير مألوفة، لاسيما في أفلام الواقع، إضافة إلى عرضه لطقوس غريبة لقبائل مختلفة تعيش على هامش الحضارة وبنزعة تجارية ساخرة.
أفلام تقوم بتشويه الشكل وتهديم للموضوع فليس بالضرورة أن يرى المشاهد صورا إنما هو تجريد في المطلق
فيقع فيلم “موندو كان” على حدود التوصيفات السينمائية عن ماهية السينما الوثائقية، وكذلك على حدود المخرج المنصوص عليها في توصيف السينما الوثائقية وفي مساحة تلاعبه بالمشاهد، كبناء الأحداث بطريقة يضيع فيها الواقع الفعلي “الوثائقي” والواقع المبني سينمائيا “الروائي“.
وتوقف عبدالأمير ليس فقط محللا للأفلام ولكن أيضا راصدا ومتتبعا للكتابات التي واكبت وساهمت في تطور وتمرد صناعة الفن السينمائي شكلا وموضوعا، فتوقف عند تطور الفيلم الوثائقي وتشكل سينما الأكستريم انطلاقا من وليام غرين المخترع البريطاني الذي قدم فيلما لا يتجاوز بضع ثوان، سابقا أديسون والأخوة لوميير بوقت قصير، وباتيه، جورج ميلييس الأب الروحي للمؤثرات الخاصة بفن السينماتوغراف، ليستعرض بعد ذلك أفلام الحرب العالمية الأولى، مذكرا بمساهمات البريطاني جون غريرسون النظرية في تلك المرحلة المبكرة من تاريخ السينما، وهي كتابات انحازت لفن تصوير الواقع، ودفعت نحو فهم جديد للسينما الوثائقية فأخرجته من المرحلة الجنينية وأصبح بفضل قراءاته النقدية أساسا نظريا متينا للسينما الوثائقية.
وقدم تحليلا لنماذج لأفلام أكستريم انطلاقا من الفيلم الأول “نانوك رجل الشمال”، وذهب إلى العراق ليقدم أفلاما اعتبرها أكستريم وهي “شمعة لمقهى الشهبندر“، “دورة الفيلم الوثائقي“ و”حياة بعد السقوط”، وتوقف مع أفلام الموندو، ومع بعض أهم الكتاب والمخرجين الذين آمنوا بالفن الجديد وأسهموا في وضع نظريات وفهم خاص بالسينماتوغراف في أوقات مبكرة من تاريخ ظهور هذا الوسيط الفني. ولم يكن هؤلاء منظرين فحسب، بل كانوا مخرجين طليعيين برهنوا على أحقية الفن الجديد وعلى مكانته بين الفنون البصرية الأخرى، مثل جون غريرسون، سيرغي أيزنشتاين ودزيغافيرتوف.